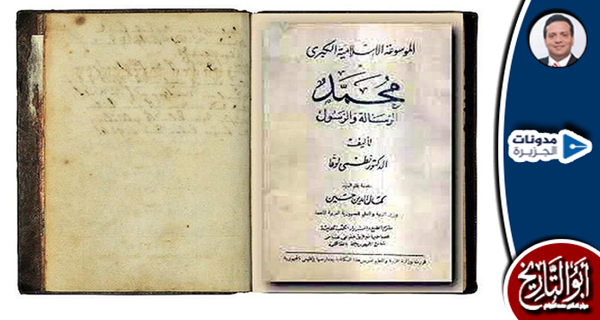كان الدكتور نظمي لوقا كاتبا مجيدا وأديبا مرموقا ومثقفا كبيرا وكان محبا للحقيقة والفلسفة قادرا على التذوق والنقد والتأليف والترجمة لكنه عانى في حياته من السياسة على الرغم من تميز إنتاجه، وسمو فكره، وقوة عرضه لفلسفته، وقد جني عليه حبه لدين الأغلبية في وطنه، وهو خلق كان يستحق التمجيد لا التجني، لكن ما حدث هو أن حبه للإسلام جعل بعض القيادات المسيحية ينظرون إليه ويقدمونه ويقيمونه بريبة لا مبرر لها، حتى عدّه بعضهم متأثرا بالدعوة الإسلامية. لخص الدكتور نظمي لوقا حياته وفلسفته وموقفه من الإسلام في قوله: “لئن كنت أنصفت الإسلام، في كتاباتي، فليس ذلك من منطلق التخلي عن مسيحيتي، بل من منطلق الإخلاص لها، والتمسك بجوهرها وأخلاقياتها”.
تمثلت في حياة الدكتور نظمي لوقا رغم تسامحه وإنصافه أصداء ما نشأ من الصراع والتعصب الديني المكبوت في البيئة المصرية في عهد ثورة 23 يوليو 1952، وليس هذا بالأمر الغريب في الحياة الثقافية. وباختصار شديد فقد كتب الرجل كتاباً بعنوان: “محمد.. الرسالة والرسول”، أنصف فيه النبي محمد صلي الله عليه وسلم، وقد نشرت مجلة “الإذاعة والتليفزيون” هذا الكتاب مع عددها الصادر في شهر رمضان الموافق ليناير 1959، ونال الكتاب ترحيب دوائر كثيرة في مصر وخارجها، وأعجب وزير التربية والتعليم كمال الدين حسين بالكتاب وبفكرة أن يكون كاتبه أو مؤلفه مسيحياً مصرياً، فقرر أن يدرس الكتاب في مدارس الوزارة على نحو ما تدّرس الكتب التي تسمي في مناهج اللغة العربية: “الكتاب ذو الموضوع الواحد” ويتعارف الطلاب على تسميتها من باب الاختصار: القصة. كان مثل هذا التصرف مثاليا ومطلوبا في بداية 1959 في عهد الوحدة مع سوريا، بكل ما كان فيها من إيجابيات وبكل ما فيها أيضا من إيجابيات سلبية عامة، وبكل ما فيها أيضا من إيجابيات وسلبيات أيدولوجية، وفي ظل الحديث عن القومية العربية، وعن الوحدة الوطنية والمثل العليا، وفي ظل ما كانت الثورة قد اختارته بالفعل وفي صمت من اللجوء إلى تقوية القيم المشتركة بين الأديان.. لكن أصابع العبث بوحدة الوطن كانت موجودة أيضا. بعدما رأي وزير التربية والتعليم كمال الدين حسين أن يقرر الكتاب على مدارس الوزارة، كما ذكرنا، ثارت ثائرة بعض المسيحيين، قائلين أن في تقرير الكتاب ما يجرح شعور المسيحيين الذين لا يؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام!، وقد واكبت الحملة على هذا الكتاب ومؤلفه خطوة عبد الناصر الحاسمة في القبض على الشيوعيين والإلقاء بهم في السجون، في حملته الشهيرة على الشيوعيين والتيارات اليسارية، (وهي الحملة التي بدأت في ليلة رأس السنة الفاصلة بين 1958 و1959)، وهكذا شُغلت الحياة الثقافية بمادة جديدة للحوار أو الحراك المحدود في ظل شمولية النظام.
ومن عجائب القدر أن واحدا من أبطال القصة في الجانب الآخر كان راهبا حديث العهد بالرهبانية، وبصراحة شديدة لا يجوز تأجيلها فإنه رغم السرية التي تحظي بها مؤسسة الكنيسة، فقد عرف أنه كان هو نفسه ذلك الراهب الذي أصبح فيما بعد الأنبا شنودة. وكان البابا شنودة في تكوينه الثقافي آنذاك وبكل المقاييس أقل بكثير جدا من الدكتور نظمي لوقا. تخرج الدكتور نظمي لوقا في كلية الآداب 1940 في قسم الفلسفة وبرز اسمه بين المشتغلين بالفكر، ونال التحقق والاعتراف والوجود والاحترام، فقد كان قد نشر قصصاً ومقالات، ونظم الشعر ونشر من شعره ديوانين، بينما لم يكن الأستاذ نظير جيد (الذي عُرف بعد ذلك باسم البابا شنودة) قد حقق ذاته بعد، بل إنه حتى وصل إلى قراره بالترهب في 1954 كان قد مر بتجارب عديدة قلقة وغير مكتملة بل ومتناقضة.
مع هذا فإن البابا شنودة من خلال موقعه في الكنيسة (ومن دون أن يظهر في الصورة بالوضوح الموازي) أحدث ضجة أثار بها الغبار الكثيف في وجه الكتاب وفي وجه مؤلفه الدكتور نظمي لوقا بل وفي وجه كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم الذي كان بسبب أخلاقه الجادة ونشاطه الجم وإظهاره لحسه الديني والخلقي محط هجوم متكرر من المثقفين من طرف خفي. مع هذا كله فقد عاش الدكتور نظمي لوقا بسبب سلامه النفسي حياة هادئة هادفة، وكان يحظى باحترام المفكرين والأدباء والمثقفين والقراء على مدى فترات طويلة، وكان راهب فكر بمعني الكلمة، وكان هو وزوجته الأديبة لا يبخلان بمساعدتهم، ولا بتوجيههم على شباب الأدباء، ومحبي الثقافة.
لكن هدوء حياته انقطع مع وفاته التي فجرت مشكلة كبيرة، إذ رفض البابا شنودة أن تتم الصلاة على جثمانه في أي كنيسة أرثوذكسية، وفي ظل سطوة شنودة في الحياة العامة مر هذا الموقف القاسي مشيعا بالتجاهل المقصود في حياة كانت تفتقد الكثير من معاني الإنسانية. وعلى الشاطئ الآخر كانت الدولة العميقة وأجهزة الأمن قد صعدت بالبابا شنودة حتى أصبح هو نفسه بمثابة اللاعب الأول معهم وضدهم على حد سواء. ظلت هذه الدولة العميقة تسدل ستائر النسيان على الدكتور نظمي لوقا عن عمد وتعمد وتكرار حتى جاءت وفاته لتمثل المأساة الإنسانية حين رفض البابا شنودة كما ذكرنا إن يُصلي عليه في أية كنيسة أرثوذكسية، وأصدر قراراته الفرعونية بتحريم الصلاة عليه في كل هذه الكنائس، بينما الدولة وأجهزتها الأمنية والحكومية تبتسم لأن طبيعة حكم ثورة 23 يوليو 1952 كانت قائمة على استغلال التعصب وتوظيفه مع التظاهر بالقضاء عليه.
لم تستطع الدولة المصرية، المهتمة بالقضاء على التعصب والفتنة الطائفية، أن تحافظ على الدكتور نظمي لوقا، ولم تبذل أجهزتها المتعددة أي جهد في هذا السبيل، وكان الجهل سيد الموقف بالطبع، ومع هذا بقي ذكر الدكتور نظمي لوقا عاليا فقد حافظ عليه المثقفون المستنيرون. لم ينل الدكتور نظمي لوقا من حظوظ الدولة شيئاً، وكأنما فُضل له أن يكون بمثابة فدائي ضد التعصب وضد الأمية الفكرية، يستدعيه المستنيرون إذا تحدثوا عن الإنصاف، لكنهم لا يتذكرونه عند الإنصاف. وقد امتد الظلم إلى زوجته الأديبة والصحفية صوفي عبد الله التي لم تنل ما تستحقه من تكريم لأنها فقط زوجة ذلك الرجل السمح المتسامح الذي كان المتعصبون منزعجين من مجرد انتمائه لهم.
لم يكن من السهل على أي جماعة إسلامية أن تتبني الدكتور نظمي لوقا أو تكرمه، فقد كانت مشكلات هذه الجماعات مع الدولة ومع الكنيسة تستغرق تماما ما قد يكون مطلوبا لمثل هذه المساحة من المكرمات. من الطريف أنه نشر الأستاذ أنيس منصور ترجمة لكتاب مايكل هارت: الخالدون مائة أعظمهم محمد، سارع كثيرون في نشر مدائح المفكرين العالمين في النبي صلي الله عليه وسلم، لكن مدائح الدكتور نظمي لوقا لم تستدع منهم الاهتمام ذاته، لأنهم يتجنبون البابا شنودة، ولأن شاعر الحي لا يطربه، ولأنه من الجائز أن يثني المسيحون في جميع أنحاء العالم على النبي صلي الله عليك وسلم، لكن هذا الثناء غير جائز للأقباط المصريين في عهد البابا شنودة حكيم العرب والعجم.
لم يضع أثر الدرس المتمثل في الدكتور نظمي لوقا ولا حياته هدراً، وإنما تنبهت الأجيال الجديدة من المثقفين والمهنيين إلى طبيعة ممارسات الدولة المصرية وإلى طبيعة العلاقة الخاصة بين المسلمين والأقباط في مصر، وإلى طبيعة العلاقة المفروضة التي تنتشي بنشر الأحضان وتخفي الخناجر، حتى تأتي طعنة الخناجر القاتلة من قبل قبطي متعصب لقبطي مستنير إذا أنصف الإسلام! وصحيح أن قصته لم يتح الزمن لها منْ يرويها على حقيقتها حتى الآن، لكنها نبهت الضمائر وأيقظت الوعي الوطني بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، وعلى صعوبة الخلاص من الفهم القاصر عند من وصلوا إلى سدة الحكم عن طريق غير طريق الفكر ورحابته وإنسانيته.. ولا نزال تعاني القصة بأبعادها.
نشأ الدكتور نظمي لوقا نشأة متميزة في مدينة السويس، وتردد على أحد مساجدها حيث أتم حفظ القرآن الكريم في التاسعة من عمره، وكانت الحياة المدنية في ذلك العصر الليبرالي تتيح الفرصة للمسيحيين الراغبين أن يحفظوا القرآن الكريم، شأنهم شأن أقرانهم المسلمين تقويما لألسنتهم، ودعما لثقافتهم وأخلاقهم. زاد الدكتور نظمي لوقا على هذه العلاقة إعجابا بما كان يرويه له أستاذه الشيخ سيد البخاري، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. أتم الدكتور نظمي لوقا درسته في كلية الآداب، وعمل محررا في دار الهلال وواصل دراسته العليا حتى نال درجة الدكتوراه في الفلسفة، وفي المحيط الثقافي العام كان الدكتور نظمي لوقا من أقرب تلاميذ الأستاذ العقاد إلي قلبه، حتى إنه أطلق عليه لقب “أديب الفلاسفة”.
وفي مجال الأديان التي تفوقت شهرته فيها، نذكر أن الدكتور نظمي لوقا لم يقف في إعجابه بالنبي صلي الله عليه وسلم عند حد، كما قدم كتابا جميلا عن المسيح عليه السلام بعنوان “على مائدة المسيح” بل إنه جاهر برأيه في أن الإسلام هو دين البشر، ولخص دوافعه إلى القول بهذا من خلال تأمل موقف الإسلام من الله، والإنسان، والنبوة، وحواء، والزواج، ونظام الحكم، والعلاقات بين الناس في مجال المعاملات، موثقا كل آرائه بما كان يجده من نصوص القرآن الكريم، والحديث الشريف. كما قدم كتابا قيما عن الخليفة أبو بكر الصديق، وكتابا قيما بعنوان “التقاء المسيحية والإسلام”، ظلت المسيحية في رأيه دين القلب الإنساني، لأنها لا تدعو إلى التوحيد والتنزيه فحسب، بل تجعل المعشوق الأسمى الذي يتجه إليه وجدان كل إنسان هو الله، على حين أن الإسلام دين القلب والعقل معا، يتجه للناس جميعا لا يفرق بين شعب وآخر، وعلى حين أن اليهودية دين شعب معين دون سائر الشعوب. أما كتابات الدكتور نظمي لوقا الفلسفية فقد تعددت مجالاتها بتعدد روافده، وقدم فيها مجموعة قيمة من الأفكار:
ـ “الله والإنسان والقيم”
ـ “نحو مفهوم إنساني”
ـ “الحقيقة”
ـ “الله.. أساس المعرفة والأخلاق عند ديكارت”
ـ “الحقيقة عند فلاسفة المسلمين”
في مجال الفلسفة ترجم كتاب بوجيتسكي “مدخل إلي الفكر الفلسفي”، كما ترجم دراسة مراد وهبة “المذهب عند كنط”. وفي علوم التربية قدم “يوم مدرسي مفيد” وترجم “التعليم.. ورقة عمل القطاع” (دار المعارف)، و”مقدمة إلي فلسفة التربية” (جورج نيلد). في مجال الأدب كان الدكتور نظمي لوقا مترجما مجيدا رائعا، قدم للغة العربية ترجمات جميلة نذكر منها ترجماته لـ”أوقات عصيبة” رائعة شارلز ديكنز، و”آلام فيرتر” رائعة جوته، وسيمفونية “الرعاة” لأندريه جيد. كذلك فقد ترجم كتابا مهما في تاريخ الأدب: “الأدب الأمريكي” تأليف ويجر، وراجع ترجمة كتاب مهم آخر بعنوان “شكسبير وراسين وإبسن في مراحلهم الأخيرة”، من ترجمة عبد الله حسين.
كان الدكتور نظمي لوقا من مترجمي الثقافة العلمية المتميزين وفي هذا الميدان فإنه ترجم مجموعة مهمة من الكتب منها “مكافحة الضوضاء” تأليف بيرلاند، وهو كتاب مرجعي، و”الإنسان والطبيعة”. وفي مجال النقد قدم الدكتور نظمي لوقا كتابا لم يلق حظه من الشهرة عن ثلاثية نجيب محفوظ وذلك في العصر الذي سبق فوز محفوظ بنويل، وتسابق النقاد في الكتابة عنه. كما قدم عديدا من الأعمال التي تصنف تحت عنوان “المختارات الأدبية” وله في هذا المجال: روائع خالدة (الأنجلو)، وأفانين من العلم والأدب والفكاهة. توفي الدكتور نظمي لوقا في 21 يونيو 1987، وأعادت روز اليوسف نشر كتابه القنبلة بعد خمسين سنة من صدوره.
تم النشر نقلا عن موقع مدونات الجزيرة
لقراءة المقال من مدونات الجزيرة إضغط هنا
للعودة إلى بداية المقال إضغط هنا
 موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ
موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ