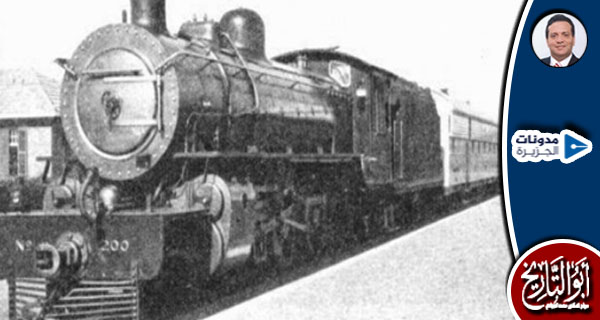
كانت سكة حديد الحجاز التي أنجزتها حكومة الدولة العثمانية بفضل تعاون وتمويل المسلمين وأموالهم نموذجا مُبكرا للنجاح المُبهر في مشروعات البنية التحتية عابرة الدول والقوميات، لكن تاريخ هذا المشروع العظيم وحجم الإنجاز فيه سرعان ما خبا لسبب واحد فقط وهو انتهاء عهد الدولة العثمانية ونشأة كيانات جديدة كانت معنية بأن تبرر (وتبرز) خيانتها للدولة العثمانية وعملها ضد مصلحة هذه الدولة وضد مصلحة المسلمين فضلا عن مصلحة الشعوب التي أصبحت هذه النُظم الجديدة مُتحكمة في أمرها بما تشاء من فرض الظواهر المعنوية المعادية للهوية الإسلامية ورواية التاريخ بأسلوب مُخالف للحقيقة. وسأحاول في عُجالة أن ألخص حجم الإنجاز العظيم الذي لم يتكرر منذ مائة عام، وإن كان الإسرائيليون قد بدأوا في الآونة الأخيرة يُبشرون بقدرتهم على إنجاز مشروع شبيه، وإن لم يكن بكامل إنجاز المشروع القديم.
أولا: بلغت أطوال هذه السكة قرابة ألفي كيلو متر، وإذا علمنا أن بعض الدول الرائدة في إدخال السكك الحديدة لم تكن قد وصلت إلى هذا الرقم، ولم تصل إليه إلا بعد ذلك بكثير، فإننا نُدرك حجم وضخامة الإنجاز الذي تم في إنجاز ما يزيد على ألف وتسعمائة متر من السكك الحديدية، وقد تمثلت الصعوبة الكبرى في هذا المشروع في أنه تم في أرض غير مستوية وغير سهلة، فقد وصلت خطوط السكك الحديدية إلى مستوى 400 متر فوق سطح البحر في بعض المناطق و200 متر تحت سطح البحر في مناطق أخرى، ويكفي هذا للتدليل على حجم وطبيعة الإنجاز الإنشائي الذي كان يتطلب كما نعرف في السكك الحديدية أن يكون مستواها من بدايتها إلى نهايتها هو نفس المستوى سواء استدعى هذا بناء خطوط السكك عالية عما يُحيطها أو منخفضة عما يُحيطها، وما يستتبعه هذا من أعمال إنشائية كثيرة وضخمة.
ثانيا: كان السلطان عبد الحميد الثاني هو الذي تحمس للمشروع، وكان الذي اقترحه عليه وتولاه ورعاه هو أحمد عزت العابد على نحو ما ذكرنا في مدونة سابقة، وقد سمي المشروع باسمه “سكك الحجاز الحميدية” وأطلق في ذكرى توليه العرش في أول سبتمبر 1900 وكان من الذين بذلوا الجهد في إنجازه كثير من العرب العاملين في ظل العثمانية ومنهم محمد فوزي باشا العظم والي دمشق ووالد الرئيس السوري خالد العظم، وكان الخط الرئيسي يمتد من مزيرب إلى درعا إلى الزرقاء إلى دمشق إلى عمان إلى معان إلى تبوك إلى مدائن صالح إلى المدينة المنورة ويبلغ طوله 1464 كيلومتر أما الخط الواصل إلى شرق البحر فكان يمتد ما بين القدس وحيفا ودمشق وبيروت وحلب.
ثالثا: كانت النتيجة الفورية لإنشاء هذا الخط أن ارتفعت أعداد الحجاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، ارتفعت الأعداد من 80 ألف إلى 300 ألف حاج.
رابعا: وصلت تبرعات المسلمين لبناء هذا الخط إلى 4 مليون ليرة تركية وهو ما يوازي أكثر من 85 % من تكلُفته التي بلغت 4,5 مليون ليرة وتكفل الوازع الديني وحده بكل هذا الإخلاص لهذا المشروع الحضاري، وكانت الدولة العثمانية عند حسن الظن بها فلم تبخل على من تبرعوا لهذا المشروع بالأوسمة والميداليات والشهادات على نحو ما كان معهودا في ذلك الزمان.
خامسا: تمثل قصر نظر العرب الشديد فيما لقيه هذا الخط العظيم من كراهية العرب له، وقد فهم الأوربيون هذا في إطار ما وصفوه بأنه كراهيتهم الوراثية (أو الفطرية) لأي رابطة تُقوي الصلة بينهم وبين بعضهم البعض، وهي الصفة التي يذهب بعض مؤرخيهم إلى القول بأنها كانت السبب الحقيقي في سقوط دولة العرب في الأندلس، وقد ذكرتُ في إحدى محاضراتي في أوروبا أن بعض المواطنين في مناطق البدو في الأردن كانوا لا يزالون حتى سنوات قريبة يتذكرون أن أكبر فائدة عادت عليهم من الثورة (!!) التي قادها الشريف حسين كانت هي الفلنكات الخشبية الضخمة التي ورثوها بالمجان بعد تدمير السكك الحديدية، وسرقة خطوطها.
فقد ظلت هذه الفلنكات في أماكنها يلجأ إليها هؤلاء البدو من عام لآخر ليستدفئوا بخشبها في برد الشتاء، وهكذا يظن هؤلاء أن الثورة العربية (المنكوبة) أورثتهم هذه الثروة من أخشاب التدفئة، ولا يدركون أن السكك الحديدية لو ظلت على كيانها الذي أقامه العثمانيون لارتفع مستوى دخل بلادهم أضعافا مضاعفة ولنقلتهم من حال الفقر المدقع إلى ثراء لا يقل عن الثراء الأوروبي في المناطق الواقعة على مثل هذا الخط الحضاري الذي لا يوجد مثله استراتيجيا في أمريكا ولا أوروبا حتى الآن.. لكن هذا المثل البارز على الترويج بالباطل للخراب يدلنا بكل وضوح على قيمة الوعي وعلى نتائج أزمة غياب الوعي.
سادسا: تكشف لنا كتب التاريخ الأوروبي عن تلك الفترة كثيرا من الحقائق الجوهرية في نظرة الغربيين إلى مستقبل التنمية في الأقطار العربية (سواء في ذلك العثمانية أو التي خرجت من الحرب العالمية الأولى إلى مسميات قومية وقُطرية)، وعلى سبيل المثال فإن الصحافة البريطانية شنت حملة على هذا المشروع وصورته (بأقلام مناصريها العرب) على أنه نهب لأموال المسلمين، وكان السبب في هذا أن الخبرة الهندسية كانت ألمانية القيادة وضمت بعض الفرنسيين والنمساويين والبلجيكيين بينما لم يشترك فيها أحد من الإنجليز.. لكن العجيب في الأمر أن بعض الألمان تورطوا أيضا في مهاجمة المشروع ومنهم سفير ألمانيا لدى الدولة العثمانية.

لكن هذا يهون إذا علمنا أن معاهدة سيفر المشئومة (1920) أجبرت الدولة العثمانية على التخلي عن حقوقها في هذا الخط أن تترك ملكيته للدول التي يمر بها لتتولى هذه الدول تخريبه بنفسها إلا بعض أجزاء كان يستحيل تخريبها لكثافة استعمالها وفي مقدمتها الخط الواصل بين العاصمتين الأردنية والسورية وإن كان هذا التدهور قد ظل يُلقي بتبعاته المتكاثرة على كل مكونات ومقومات هذا الخط حتى توقف في 2011.
سابعا: من الطريف في هذا المقام أن نذكر للمهندسين الأمريكيين ريادتهم المبكرة (التي يُنكرها مؤرخونا ويظنون أنها لم توجد إلا بعد الحرب العالمية الثانية) فمن الثابت أن أول من اقترحه 1864كان مهندسا أمريكيا وقد تقدم بالاقتراح للسلطان عبد العزيز بالمواكبة لابتهاج مصر بإنشاء مصر لخطوطها الحديدية، وقد أعجب بها السلطان عبد العزيز حين زار مصر 1863 في مطلع عهد الخديوي إسماعيل الذي تسلم مصر بعد ما كانت خطوط سككها الحديدية قد تمت في عهد الواليين المظلومين عباس وسعيد.. لكن السلطان عبد العزيز لم يتحمس وقتها للمشروع.
ثامنا: من المدهش أن إسرائيل التي طرحت فكرة إعادة مثل هذا الخط لتقفز على الصراع السياسي بتعاون اقتصادي، لا تكف عن التلويح بإنجازه ليكون لها دور الأسد فيه، لكنها حين تفعل ذلك لا تقرنه كما يفعل العرب بكراهية العثمانيين، بل إنها رغم كراهيتها التامة للدولة العثمانية وشماتتها في نهايتها لم تغفل أن تحتفل بالذكرى المئوية لوصول خط سكة حديد الحجاز إلى حيفا الفلسطينية التي لم تكن بالطبع خاضعة للاحتلال الصهيوني في ذلك الوقت الذي وصلتها سكة الحديد العثمانية (1905) ومع هذا فقد احتفلت إسرائيل بما يكره العرب أن يحتفلوا به حقدا على أنفسهم.
تم النشر نقلا عن مدونات الجزيرة
لقراءة التدوينة من موقع الجزيرة إضغط هنا
للعودة إلى بداية التدوينة إضغط هنا
 موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ
موقع الدكتور محمد الجوادي | أبو التاريخ



